ياسر بركات يكتب عن مؤامرة رفع الأسعار بين الحقائق والشائعات... إنه الجنون!
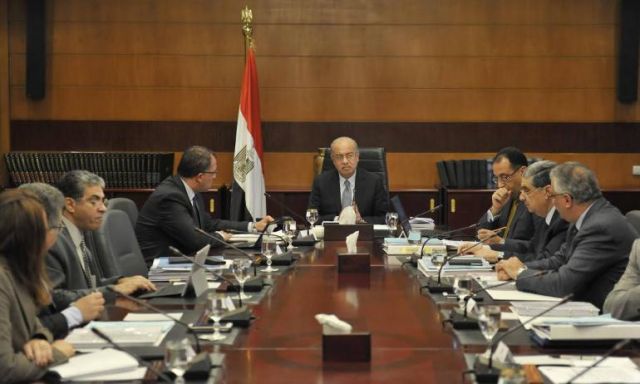
من وراء إشعال النار فى
الأسعار ليلة 30 يونيه ؟!
علاوة السيسى .. وجحيم الوزير
تفاصيل وأسرار "موقعة البنزين"
src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
حكومة شريف إسماعيل وسياسة " التنكيل " بجيل كامل من المصريين
ـ مسلسل الارتفاع مستمر حتى 2019 .. وشروط البنك الدولى تعجيز لمصر وحكومتها
مكتوب على أبناء هذا الجيل تناول "الدواء المُر " لعلاج خطايا الماضى .. ولكن هل يكون المستقبل أفضل ؟!
ـ لماذا تعمدت الحكومة تجاهل قرارات الرئيس بزيادة المعاشات ودعم بطاقة التموين؟!
استيقظنا صباح الخميس على القرار الصعب الذي كنا نتوقعه، لكننا تشككنا في قدرتنا على احتماله. قرار رفع الدعم الجزئي عن أسعار المواد البترولية بنسبة تتراوح بين 5.6% و55 %، ليرتفع سعر "بنزين 80" من 2.35 إلى 3.65 جنيه لكل لتر ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 55.3 في المائة، وسعر "بنزين 92" من 3.5 إلى 5 جنيهات لكل لتر، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 42.9 في المائة. كما ارتفع سعر السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 55.3 في المائة، وتم رفع سعر أنبوبة "البوتاجاز" إلى الضعف من 15 جنيهاً إلى 30 جنيهاً للأسطوانة.
اللافت للنظر، هو أن محاولات الحكومة للشرح والإقناع، عادة ما تبوء بالفشل.. ربما لأن عددا من الوزراء فقدوا حيويتهم المطلوبة. وبالتالي لم تعد وجهة نظر الدولة مطروحة بشكل أو بآخر في ظل مزاج عام اعتاد منهج (تقاطع النيران).. أي يريد أن يتمتع بتنوع الرؤى.. ويريد أن يسمع الرأي والرأي الآخر .. لكنه الآن لا يسمع سوي رأي واحد.. وصوت واحد.
هذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة الدعم الجزئي عن الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي. إذ لم تمض أيام إلا وأعلنت وزارة البترول في الرابع من نوفمبر رفع سعر "بنزين 80" إلى 2.35 جنيه للتر من 1.60 جنيه وسعر "بنزين 92" إلى 3.50 جنيه للتر من 2.60 جنيه. ووقتها قفز معدل التضخم السنوي في النقل والمواصلات في إجمالي الجمهورية إلى 21.6% في نوفمبر مقابل 8% في أكتوبر، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما قفز التضخم الشهري في النقل والمواصلات إلى 12.6% في نوفمبر، مقابل 1.5% في أكتوبر. وأرجع الجهاز هذه القفزة إلى زيادة تكاليف المواصلات الخاصة بنحو 23.3% في نوفمبر مقارنة بأكتوبر، وخدمات النقل بنسبة 10.9%.
كل هذه النتائج، جاءت مباشرة بعد قرار الحكومة في 3 نوفمبر زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات بنسب. ووقتها قال الجهاز الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان، إن "الزيادة الملحوظة في معدلات التغير الشهرية والسنوية ترجع لانعكاسات وآثار قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وقرار زيادة أسعار المواد البترولية". وبحسب بيانات الجهاز، قفز التضخم السنوي في نوفمبر إلى 20.2% في إجمالي الجمهورية، مسجلا أعلى مستوى في 8 سنوات، مقابل 14% في أكتوبر.
بهذا الشكل، كان من المنطقي ألا يلتفت أحد إلى قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أيام التي أعلن فيها زيادة دعم الفرد في البطاقة التموينية من 21 جنيهاً (1.16 دولار) إلى 50 جنيهاً (2.8 دولار)، وإقرار الحكومة حزمة ضمان اجتماعي شملت علاوة غلاء بنسبة 10 بالمائة وزيادة معاشات التقاعد والدعم النقدي الموجه للأسر الفقيرة "تكافل وكرامة"، بجانب زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي. وهو ما تكلف 75 مليار جنيه (4.1 مليار دولار). لم يلتفت أحد إلى ذلك وكان التركيز على أن زيادة أسعار الوقود ستتبعها زيادة في أسعار جميع السلع والمنتجات، لتزيد من الأعباء على كاهل المواطنين.
هل قدر هذا الجيل أن يتحمل وحده فاتورة الإصلاح المتراكمة منذ نصف قرن على الأقل؟!
وكيف تترك الحكومة كل أيام السنة وتعلن عن الزيادة في هذا اليوم بالتحديد، اليوم السابق لذكرى 30 يونيو؟!
كل الأنظمة السابقة كانت تخشى الاقتراب من منظومة الدعم خوفاً من الغضب الشعبي، وكان يتم التأجيل لتتحمل الأجيال التالية تبعات أسوأ، وذلك عبر الاقتراض، حتى تجاوزت نسبة الدين العام 107% من الناتج المحلى الإجمالي. وبالتالي استهدفت الدولة خفض هذه النسبة إلى 95% خلال العام المالي 2017/2018 ولهذا تم وضع خطة طويلة الأجل لخفض قيمة دعم السلع والخدمات مع توفير إجراءات لحماية الفئات المستحقة من الزيادة المتوقعة فى الأسعار.
كلام منطقي.. لكن يقابله أن المواطن وحده هو الضحية، بينما كانت معاناته ستقل لو تم تحسين مناخ الاستثمار وتنفيذ مشروعات تنمية تجذب المستثمرين مع مكافحة الفساد بصورة جادة، الأمر الذي كان كفيلًا بتوفير أكثر من 200 مليار جنيه تُضاف إلى خزينة الدولة.
هكذا، وصلنا إلى ما نحن فيه. ورأينا حالة التدهور في الاقتصاد المصري، التي لا تخطئها عين، سواء كان ذلك على صعيد الأفراد أو الاقتصاد الحكومي أو مجتمع الأعمال أو في علاقات مصر الاقتصادية الخارجية.
ونشير هنا إلى أن مصر، عرفت ولا تزال، نوعا فريدا من الحرب النفسية المكثفة، التي كان لها تأثير بالغ في مسارات التغيير وتقاطعات التدمير، التي تحاول أطراف خارجية صناعتها الآن، بمساعدة أطراف داخلية للأسف، وقد لا أبالغ لو قلت إن ما يحدث داخل مصر الآن أخطر بكثير مما قد يقوم به الأعداء ضدنا، بعد أن أصبحت مرتعا لما توصف تجاوزا بأنها "وسائل إعلام" تجاهلت دورها أو أدوارها وتفرغت للشائعات.. أو التحريض.. أو التشويه.. أو التخبط، في ظل عدم وجود منظومة إعلامية لها نسق واضح تعبر عن مؤسسات الدولة، وفئات الشعب.. فكان أن أصبحنا فريسة لسيول من الدعايات والشائعات، تأسست علي أنه يمكن هدم الاستقرار فقط في النفوس قبل أن يتم تدميره علي أرض الواقع، فقامت بتصويب مدفعيات الخوف إلي عقول الشعب كل في موقعه وكل حسب مصلحته.. لنشر حالة من الهلع والفتن.. ولو لم يتم تدارك ذلك، ستكون النتيجة مأساوية!
أيضا، لا يمكن أن نتغافل "الحرب الاقتصادية" ضد مصر، مع ما تقوم به الجماعات الإرهابية من تفجيرات أثرت بدرجة كبيرة على السياحة وعلى غيرها من النشاطات الاقتصادية.
ويستطيع كل من له عينان أن يرى بوضوح أن مصر تتعرض لمؤامرة اقتصادية خططت لها وتديرها دول وجهات خارجية ويشارك في تنفيذها، داخلياً، شخصيات وكيانات وجهات متعددة.
ويمكن لكل ذي عقل أن يربط بسهولة بين تفجير العديد من الأزمات الداخلية وإظهارها على السطح، وبين المخطط الذي يستهدف حصار مصر اقتصاديا، بل وتدمير الاقتصاد وتخريبه.
2
آليات تنفيذ المخطط لها عدة مستويات والمشاركون فيه لهم أدواتهم الخاصة ولديهم وسائل إعلام تعمل من الداخل والخارج وينفقون عليها ملايين الدولارات.. وبينهم أيضا رجال أعمال وشركات تعمل في السوق المصري، وعدد من كبار تجار العملة والمسيطرون على سوق الصرف السوداء.
والمخطط لا يحكمه فقط عملية سياسية، بل هناك جهات وأشخاص انتهزوا الفرصة ووجدوها فرصه للإثراء السريع باستغلال الأزمات الاقتصادية وعلى رأسهم كل المتربحين من الأنظمة السابقة لخسائرهم الفادحة من تغيير الأنظمة وبدء محاسبة المنحرفين منهم.
المتآمرون على مصر وجدوا في الجانب الاقتصادي بيئة خصبة لممارسة الضغوط وانضم إليهم رجال أعمال مصريون وعرب وأجانب، اعتقدوا أن الفرصة جاءتهم على طبق من ذهب ليقوموا بالضغط على الرئيس كي يخضع لمطالبهم ويحصلوا على المزايا والامتيازات التي كانوا يحصلون عليها قبل ذلك. ونشير هنا إلى أن حجم أعمال بعضهم كان قد تجاوز 70% من إجمالي مشروعات التنمية في الدولة!
بهذا الشكل، يمكننا أن نقول إن هذا الشر لا بد منه. لكننا نعرف أيضاً أن رفع الدعم، ولو جزئيا، يأتي بمردود عكسي ونتائج سلبية على المواطنين، وأن ارتفاع سعر البنزين والغاز والسولار ترتفع معه بالضرورة والتبعية أسعار تعريفة المواصلات بكل أنواعها بصورة عشوائية، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكلفة الإنتاج للمصانع التي تستخدم الوقود في تشغيل الماكينات وخطوط النقل. كما يحدث في المقابل، تراجع كبير في القوة الشرائية للمرتبات، ومن ثم زيادة في استمرار حالة الركود والكساد الاقتصادي، في ظل استغلال وجشع التجار نتيجة غياب الرقابة وعدم قدرة الدولة على ضبط الأسعار.
ونشير هنا إلى أنه كانت هناك وعود وتطمينات بأن المواطن البسيط أو محدود الدخل لن يتأثر بالظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، وأن السلع الأساسية لن يحدث تصعيد في أسعارها. وهي الوعود التي لم تتحقق. بل رأينا التوجه الأساسي لحكومة شريف إسماعيل يناقضها ويخاصم استقرار الأسعار، مع التسليم بأن كثيرا من القرارات الصعبة كان لازما وضروريا لتحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي. فمن الطبيعي أن يتم رفع أسعار سلع بعينها من أجل الحصول على الأموال اللازمة لاستكمال المشروعات المخطط لها. فقط كنا نتمنى لو تمت مراعاة محدودي الدخل والسلع الأساسية وهو ما ننتظر تداركه خلال الفترة المقبلة.
فهل تكفي تصريحات شريف إسماعيل التي تلت القرار، والتي أعلن فيها أن الأسعار الجديدة للوقود تأتي ضمن خطة خفض الدعم التي بدأت 2014 وتنتهي 2019 وفق توصيات صندوق النقد الدولي، وأنه لا مفر من القرار قبل حسم قضية الدعم العام القادم؟!
رئيس الوزراء، لفت إلى أن "المرحلة الحالية لا تحتمل تأجيل القرارات إذ لا بد من مواجهة قرارات الدعم بحزم ليصل إلى مستحقيه، وإلا فالعواقب وخيمة على الجميع والقادم سيكون أسوأ". كما أعلن عن زيادة في أسعار الكهرباء يبدأ تطبيقها في أغسطس المقبل لفواتير يوليو، مشيراً إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولية قراراتها، مؤكداً أن حجم الدعم وصل إلى 150 مليار جنيه وأن الموازنة العامة للدولة لم تعد تتحمله. وفي المقابل، أوضح أن الزيادة لن تؤثر على تذاكر المترو والقطارات وحتى على رغيف العيش إذ أعلن وزير التموين أن الحكومة ستتحمل فارق تكاليف إنتاجه بسبب رفع سعر الدولار.
وما أثار الدهشة أكثر، هو تصريح أبو بكر الجندي، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، حينما أعلن عن حرص الرئيس السيسي على معرفة تأثير القرار على محدودي الدخل بشكل خاص والمواطنين بشكل عام، مما دفع المركز لإجراء دراسة على مختلف المحافظات ووسائل المواصلات لمعرفة نصيب الفرد من الزيادة.
حتى نكون منصفين، فإن الحكومة لا تتحمل العبء وحدها لأنها جزء من الشعب، والمواطن يريد الاستهلاك ولا ينتج، ودائمًا ما يحمّل المسؤولية للحكومة. ، والشائعات من أهم الأسباب المساهمة في الغلاء، فالمواطن لا يدرك حقيقة الواقع، وأي السلع التي ارتفعت أسعارها، وقيمة ذلك الارتفاع، إلا أنه يردد ما يتم تداوله، دون وعي. بما يعني أن هناك ارتفاع أسعار مبرر وآخر غير مبرر، وأن الحديث المتواصل عن وجود ارتفاع أسعار بشكل عام دون التدقيق هو أصل الارتفاع.
الكل يتحمل نصيبًا من التهمة، فالدولة مسؤولة عن جزء من زيادة التكاليف؛ لأنها لا تتدخل، وتكتفي بالاعتماد على آليات السوق الحر، وهناك جزء كبير من ارتفاع الأسعار يقع على عاتق التجار، فهم يستغلون المواسم لزيادة الأسعار بشكل جنوني، مستغلين عدم قدرة الحكومة على التحكم في السوق، فهناك ما يزيد عن 3 آلاف مركز تجاري، ولا تستطيع الجهات الرقابية متابعتها أو ضبط أسعار السلع والسيطرة عليها؛ لعدم وجود قانون يعطيها الحق في التدخل في السوق بتعديل الأسعار.
كما يتسبب المواطنون أحيانًا في رفع الأسعار بسبب كثرة الطلب في فترات المواسم، مثل رمضان والأعياد، فاستهلاك المواطنين يزداد خلال شهر رمضان، وبعض العائلات تصل لزيادات 3 أضعاف، بعكس شهور العام الأخرى، لكننا لا يمكن أن نعتبر المواطن هو المسؤول الوحيد عن ذلك؛ فتزايد شراء السلع لتخزينها في فترة معينة أو في مواسم بعينها يستغله التجار احتكاريًا لزيادة أسعارها.
وعليه، تكون الكرة في ملعب الحكومة ومدى قدرتها على معالجتها للوضع الاقتصادي الكلي وكيفية مواجهتها للتضخم، والهبوط بمعدلاته إلى مستويات معقولة، وزيادة الأجور وضبط الأسواق لضمان عدم ارتفاع أسعار السلع التي لا يوجد مبرر حقيقي لارتفاعها، مع توسيع شبكة الضمان الاجتماعي لتغطي كافة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، والتي هي غالبية عدد السكان.
وهكذا، تكون الحاجة ملحة وضرورية لوجود بورصة للأسعار؛ لتحديد السعر، ومحاسبة من يخالف الأسعار، بأن تقوم المؤسسات الحكومية وجهاز حماية المستهلك بدور الرقيب على السوق، وأن تحدد الربح، كما تفعل بعض الدول بتحديد هامش ربح التجار بـ 20% للملابس، و25% للسلع الغذائية، وهذا الأمر المتبع في اليابان وإنجلترا مثلاً.
3
ومن المعضلات، أن يحدث ذلك، بعد أن توقع تقرير جديد أن يحمل عام 2017 "تفاؤلا حذرا" للاقتصاد المصري، بشكل يعتمد أساسا على قدرة الحكومة المصرية الحفاظ على برامج الإصلاح والتنفيذ المحكم لإستراتيجية التنمية المستدامة. ولا أتحدث عن تقرير محلي بل عن النسخة الـ16 من تقرير "التوقعات الاقتصادية في إفريقيا"، الذي صدر في 22 مايو الماضي، بشراكة بين البنك الإفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو التقرير الذي ركز في نسخته الجديدة على التصنيع.
قال التقرير إنه في حالة استمرار إصلاح السياسات الاقتصادية والبنيوية في مصر كما حددت ذلك خارطة الطريق، فيتسارع النمو الاقتصادي خاصة مع عودة الثقة لدى المستثمرين وتطور إنتاج مجال الغاز وعودة النشاط السياحي، رغم المشاكل الداخلية والارتباك الاقتصادي العالمي الحاصل، متحدثا عن أنه بوسع مصر الاعتماد على مؤهلات المجالات الصناعية ومحال المقاولات من أجل تحسين النمو وخلق فرص العمل.
وأبرز التقرير أن احتياطي العملة الصعبة تحسن منذ اتخاذ البنك المركزي المصري لقرار تحرير قيمة العملة نهاية 2016، غير أنه مع ذلك، يبقى من الصعب محاربة العجز في الموازنة والميزان التجاري خلال هذا العام، رغم بذل جهود في هذا الصدد تعتمد على قانون مالية العام الماضي ووضع مشروع قانون للاستثمار وارتفاع العائدات من الضرائب.
وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي بمصر إلى 4.6 بالمائة بدل 3.9 المسجلة عام 2016، إلّا أن نسبة التضخم سترتفع وفق التوقعات إلى 16.9 بالمائة هذا العام. وتابع التقرير أن الاقتصاد المصري يبقى متنوعا إجمالا، إلّا أنه ورغم وجود تصنيع قوي، فالمستثمرين لم يستطيعوا خلق تغيير حقيقي في خلق مناصب العمل، كما أن النمو الاقتصادي بالبلاد يعتمد كذلك على ضرورة توسيع الولوج إلى الموارد الطبيعية والرأسمال وتوفير التكنولوجيات الحديثة واليد العاملة المؤهلة.
4
وقت إعلان وثيقة تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، كان من أبرز المسائل، التي أثارت جدلا واسعا فور الكشف عنها، أربعة أمور أساسية، أولها الاتفاق بين الحكومة والصندوق على خفض دعم المواد البترولية ليصل في عامي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ إلى ١٩ مليار جنيه، من إجمالي قيمته البالغة في ٢٠١٦ - ٢٠١٧ حوالي ٦٢.٢ مليار جنيه. أي أقل من الثلث، وهو ما يعني أن أسعار المواد البترولية كافة سوف تشتعل، حيث أن البديل الوحيد أمام الحكومة لخفض الدعم على المواد البترولية تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي هو رفع الأسعار، وخاصة أن أي زيادة في الإنتاج لم تتحقق كبديل لرفع الاسعار. كما أن ارتفاع الاسعار لتخفيض الدعم سوف يكون كبيرا للغاية، لكي تتمكن الحكومة من تحقيق المعدلات المطلوبة حسب الاتفاق مع الصندوق، وبخاصة في ظل ارتفاع تكاليف استيراد المواد البترولية، التي تستوردها مصر من الخارج لتغطية الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من الضعف، وما يتوقع من الارتفاعات لأسعار النفط عالميا بعد قرار دول منظمة الأوبك تخفيض الإنتاج لرفع الأسعار.
أما المسألة الثانية، فكانت أم الاتفاق، الذي كشفت عنه وثيقة صندوق النقد الدولي المعلنة، تضمن كذلك، رفع الدعم الكامل عن الكهرباء بحلول عام 2020، وهو ما يعني تحديد أسعار الكهرباء وفقا لسعر التكلفة. وذلك يؤشر إلى أن الأسرة المصرية سوف تتحمل بعد ثلاث سنوات التكلفة الكاملة مع عدم رفع المرتبات أو توفير موارد تسهم في رفع مستوى معيشة المصريين.
والمسألة الرابعة هي أن الحكومة المصرية وافقت على تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017 - 2018. وما إن جرى الكشف عن هذا الأمر حتى انهارت البورصة المصرية في غضون ساعات، وحققت خسائر بلغت أكثر من 19 مليار جنيه خلال يوم واحد، ما حدا بالرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدعوة إلى اجتماع عاجل ظهر الخميس ، 19/01/2017، برئيس الحكومة والوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة المعنية، واتخاذ قرار بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ٣ سنوات بعد انتهاء موعدها المحدد في محاولة لإنقاذ البورصة من الانهيار، وأيضا لتشجيع المستثمرين.
وتعلقت المسألة الرابعة بما كشف عنه الرئيس التنفيذي لصندوق النقد حين قال إنه فوجئ بأن حجم انخفاض الجنيه المصري كان أكثر مما كان متوقعا، وهو ما يكشف عن أن الحكومة المصرية لم تدرس بشكل حقيقي الآثار المتوقعة لاتفاقها مع صندوق النقد على العملة الوطنية.
وفوق كل ذلك، كان من أخطر ما توقعه رئيس بعثة الصندوق هو الارتفاع المتوقع لحجم الديون الخارجية على مصر من حوالي 60 مليار دولار حاليا إلى 66 مليار دولار مع نهاية العام الحالي 2017، وإلى 102,4 مليار دولار بحلول العام 2020.
5
لسنا حالة متفردة، أو غير مسبوقة. إذ إن تفاوت التنمية الاقتصادية والتغيير الاجتماعي في العالم كله، يضعنا أمام تناقضات وتباينات حادة. وهي ليست إلا نماذج مصغرة من اللا مساواة القائمة بين العالمين الموجودين على كوكبنا: ما يسمى العالم المتقدم والعالم المتخلف العالم الأول والعالم الثالث، البلاد الفقيرة والبلاد الغنية. والانقسام الكبير ضمن كل دولة فقيرة هو أشد ترويعًا، لأن التباينات هنا شديدة الاقتراب بعضها من بعض.
ولذلك فإن ذلك التفاوت أنتج قضية جديدة أو أنها تبدو كذلك، وهي قضية العولمة، وهي القضية التي باتت تشغل الآن مساحات واسعة من الفكر الإنساني المعاصر، ونتيجة لذلك أفرزت تلك القضية الشائكة العديد من الاتجاهات التي ينبغي أن نتناولها من منظور عقلاني شامل، يحيط بها من مختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والإعلامية والحضارية، بالإضافة إلى المنظور الإنساني الذي يقدم أطروحات متعددة للسياسات الليبرالية الحديثة التي تعتمد عليها العولمة، وترسم لنا صورة المستقبل بالعودة إلى الماضي السحيق للرأسمالية. وقد وجدت تلك الأفكار انعكاسها الواضح في السياسات الاقتصادية الليبرالية التي تطبق الآن في مختلف دول العالم دون مشاركة الناس أو موافقتهم على تلك السياسات.
وهناك من يعتقد أن العولمة ما هي إلا نتيجة حتمية خلقتها سياسات معينة، بإرادة الحكومات والبرلمانات التي وقعت القوانين التي طبقت السياسات الليبرالية الجديدة، وألغت الحدود والحواجز أمام حركات تنقل السلع ورؤوس الأموال وسحبت المكاسب التي حققها العمال والطبقات الوسطى، وانتهاء بالتوقيع على اتفاقية منظمة التجارة العالمية (الجات) التي ستتولى العقوبات على من لا يذعن لسياسة حرية التجارة. ففي كل هذه الأمور لم تكن هناك حتميات لا يمكن تجنبها، بل إرادات سياسية واعية بما تفعل وعبرت عن مصلحة الشركات دولية النشاط.
وعلى ضوء ما سبق، سعت بعض الدول إلى ترشيد الرأسمالية في بلدانها، وعملت على ضبط عوامل تطور المجتمع والسلم الاجتماعي، وضرورة وجود طبقة اجتماعية متوسطة متحركة وحيوية، بحيث يكون هناك اقتصاد فيه بدائل وخيارات متعددة، وضبطت من خلالها العملة النقدية. وهذا ما يعكس نوعًا من التقارب الأمريكي الروسي في ظل نظام نقدي دولي جديد، ويعكس (ضمنًا) حكمة الصين والهند وأوروبا في إيجاد دوافع للتفاهم حول السياسات النقدية.
هذه السياسات ذات صلة مباشرة وغير مباشرة بالبعد الاجتماعي للنظام الاقتصادي الجديد تكمن في المجتمع، لأسباب ما هو عليه، وكيفية تغيره. ولذلك سعت المنظمات والهيئات الدولية والمراكز البحثية إلى دراسة تلك السياسات وأبعادها المختلفة التي جمعت بين كل ما هو فلسفي أو سياسي أو تاريخي أو أخلاقي، ومن جانب آخر، ما بين علوم سياسية أكثر ارتباطاً بمشكلات الواقع، مع طرح نظريات اجتماعية عامة، ووضع قوانين لتفسير الظواهر والتحولات الاجتماعية. وتقديم تنبؤات يمكن الحكم على صحتها من عدمه، إذا ما كانت في إطار سياقها الاجتماعي المناسب وقادرة على التجديد والتصحيح الذاتي بشرط توافر درجة عالية من الشفافية من أجل تجنب تضارب المصالح.
غير أن الغريب والمثير للدهشة هو أن تجد الحكومة غير منــشــغلة بما يدور حولها وبينما الرئيس مهموم بالإنجاز، ترى الحكومة تشارك في الاجتماعات مثل الآخرين.. تسمع ولا تضيف.. تنصت ولا تبدع.. وكأن ما يعنيها فقط هو أن تمر الأيام. وكأنك أمام حكومة موظفين، لا حكومة تقوم بمهمة في إطار التحول والإصلاح!
الأسعار ليلة 30 يونيه ؟!
علاوة السيسى .. وجحيم الوزير
تفاصيل وأسرار "موقعة البنزين"
src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
حكومة شريف إسماعيل وسياسة " التنكيل " بجيل كامل من المصريين
ـ مسلسل الارتفاع مستمر حتى 2019 .. وشروط البنك الدولى تعجيز لمصر وحكومتها
مكتوب على أبناء هذا الجيل تناول "الدواء المُر " لعلاج خطايا الماضى .. ولكن هل يكون المستقبل أفضل ؟!
ـ لماذا تعمدت الحكومة تجاهل قرارات الرئيس بزيادة المعاشات ودعم بطاقة التموين؟!
استيقظنا صباح الخميس على القرار الصعب الذي كنا نتوقعه، لكننا تشككنا في قدرتنا على احتماله. قرار رفع الدعم الجزئي عن أسعار المواد البترولية بنسبة تتراوح بين 5.6% و55 %، ليرتفع سعر "بنزين 80" من 2.35 إلى 3.65 جنيه لكل لتر ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 55.3 في المائة، وسعر "بنزين 92" من 3.5 إلى 5 جنيهات لكل لتر، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 42.9 في المائة. كما ارتفع سعر السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 55.3 في المائة، وتم رفع سعر أنبوبة "البوتاجاز" إلى الضعف من 15 جنيهاً إلى 30 جنيهاً للأسطوانة.
اللافت للنظر، هو أن محاولات الحكومة للشرح والإقناع، عادة ما تبوء بالفشل.. ربما لأن عددا من الوزراء فقدوا حيويتهم المطلوبة. وبالتالي لم تعد وجهة نظر الدولة مطروحة بشكل أو بآخر في ظل مزاج عام اعتاد منهج (تقاطع النيران).. أي يريد أن يتمتع بتنوع الرؤى.. ويريد أن يسمع الرأي والرأي الآخر .. لكنه الآن لا يسمع سوي رأي واحد.. وصوت واحد.
هذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة الدعم الجزئي عن الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي. إذ لم تمض أيام إلا وأعلنت وزارة البترول في الرابع من نوفمبر رفع سعر "بنزين 80" إلى 2.35 جنيه للتر من 1.60 جنيه وسعر "بنزين 92" إلى 3.50 جنيه للتر من 2.60 جنيه. ووقتها قفز معدل التضخم السنوي في النقل والمواصلات في إجمالي الجمهورية إلى 21.6% في نوفمبر مقابل 8% في أكتوبر، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما قفز التضخم الشهري في النقل والمواصلات إلى 12.6% في نوفمبر، مقابل 1.5% في أكتوبر. وأرجع الجهاز هذه القفزة إلى زيادة تكاليف المواصلات الخاصة بنحو 23.3% في نوفمبر مقارنة بأكتوبر، وخدمات النقل بنسبة 10.9%.
كل هذه النتائج، جاءت مباشرة بعد قرار الحكومة في 3 نوفمبر زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات بنسب. ووقتها قال الجهاز الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان، إن "الزيادة الملحوظة في معدلات التغير الشهرية والسنوية ترجع لانعكاسات وآثار قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وقرار زيادة أسعار المواد البترولية". وبحسب بيانات الجهاز، قفز التضخم السنوي في نوفمبر إلى 20.2% في إجمالي الجمهورية، مسجلا أعلى مستوى في 8 سنوات، مقابل 14% في أكتوبر.
بهذا الشكل، كان من المنطقي ألا يلتفت أحد إلى قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أيام التي أعلن فيها زيادة دعم الفرد في البطاقة التموينية من 21 جنيهاً (1.16 دولار) إلى 50 جنيهاً (2.8 دولار)، وإقرار الحكومة حزمة ضمان اجتماعي شملت علاوة غلاء بنسبة 10 بالمائة وزيادة معاشات التقاعد والدعم النقدي الموجه للأسر الفقيرة "تكافل وكرامة"، بجانب زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي. وهو ما تكلف 75 مليار جنيه (4.1 مليار دولار). لم يلتفت أحد إلى ذلك وكان التركيز على أن زيادة أسعار الوقود ستتبعها زيادة في أسعار جميع السلع والمنتجات، لتزيد من الأعباء على كاهل المواطنين.
هل قدر هذا الجيل أن يتحمل وحده فاتورة الإصلاح المتراكمة منذ نصف قرن على الأقل؟!
وكيف تترك الحكومة كل أيام السنة وتعلن عن الزيادة في هذا اليوم بالتحديد، اليوم السابق لذكرى 30 يونيو؟!
كل الأنظمة السابقة كانت تخشى الاقتراب من منظومة الدعم خوفاً من الغضب الشعبي، وكان يتم التأجيل لتتحمل الأجيال التالية تبعات أسوأ، وذلك عبر الاقتراض، حتى تجاوزت نسبة الدين العام 107% من الناتج المحلى الإجمالي. وبالتالي استهدفت الدولة خفض هذه النسبة إلى 95% خلال العام المالي 2017/2018 ولهذا تم وضع خطة طويلة الأجل لخفض قيمة دعم السلع والخدمات مع توفير إجراءات لحماية الفئات المستحقة من الزيادة المتوقعة فى الأسعار.
كلام منطقي.. لكن يقابله أن المواطن وحده هو الضحية، بينما كانت معاناته ستقل لو تم تحسين مناخ الاستثمار وتنفيذ مشروعات تنمية تجذب المستثمرين مع مكافحة الفساد بصورة جادة، الأمر الذي كان كفيلًا بتوفير أكثر من 200 مليار جنيه تُضاف إلى خزينة الدولة.
هكذا، وصلنا إلى ما نحن فيه. ورأينا حالة التدهور في الاقتصاد المصري، التي لا تخطئها عين، سواء كان ذلك على صعيد الأفراد أو الاقتصاد الحكومي أو مجتمع الأعمال أو في علاقات مصر الاقتصادية الخارجية.
ونشير هنا إلى أن مصر، عرفت ولا تزال، نوعا فريدا من الحرب النفسية المكثفة، التي كان لها تأثير بالغ في مسارات التغيير وتقاطعات التدمير، التي تحاول أطراف خارجية صناعتها الآن، بمساعدة أطراف داخلية للأسف، وقد لا أبالغ لو قلت إن ما يحدث داخل مصر الآن أخطر بكثير مما قد يقوم به الأعداء ضدنا، بعد أن أصبحت مرتعا لما توصف تجاوزا بأنها "وسائل إعلام" تجاهلت دورها أو أدوارها وتفرغت للشائعات.. أو التحريض.. أو التشويه.. أو التخبط، في ظل عدم وجود منظومة إعلامية لها نسق واضح تعبر عن مؤسسات الدولة، وفئات الشعب.. فكان أن أصبحنا فريسة لسيول من الدعايات والشائعات، تأسست علي أنه يمكن هدم الاستقرار فقط في النفوس قبل أن يتم تدميره علي أرض الواقع، فقامت بتصويب مدفعيات الخوف إلي عقول الشعب كل في موقعه وكل حسب مصلحته.. لنشر حالة من الهلع والفتن.. ولو لم يتم تدارك ذلك، ستكون النتيجة مأساوية!
أيضا، لا يمكن أن نتغافل "الحرب الاقتصادية" ضد مصر، مع ما تقوم به الجماعات الإرهابية من تفجيرات أثرت بدرجة كبيرة على السياحة وعلى غيرها من النشاطات الاقتصادية.
ويستطيع كل من له عينان أن يرى بوضوح أن مصر تتعرض لمؤامرة اقتصادية خططت لها وتديرها دول وجهات خارجية ويشارك في تنفيذها، داخلياً، شخصيات وكيانات وجهات متعددة.
ويمكن لكل ذي عقل أن يربط بسهولة بين تفجير العديد من الأزمات الداخلية وإظهارها على السطح، وبين المخطط الذي يستهدف حصار مصر اقتصاديا، بل وتدمير الاقتصاد وتخريبه.
2
آليات تنفيذ المخطط لها عدة مستويات والمشاركون فيه لهم أدواتهم الخاصة ولديهم وسائل إعلام تعمل من الداخل والخارج وينفقون عليها ملايين الدولارات.. وبينهم أيضا رجال أعمال وشركات تعمل في السوق المصري، وعدد من كبار تجار العملة والمسيطرون على سوق الصرف السوداء.
والمخطط لا يحكمه فقط عملية سياسية، بل هناك جهات وأشخاص انتهزوا الفرصة ووجدوها فرصه للإثراء السريع باستغلال الأزمات الاقتصادية وعلى رأسهم كل المتربحين من الأنظمة السابقة لخسائرهم الفادحة من تغيير الأنظمة وبدء محاسبة المنحرفين منهم.
المتآمرون على مصر وجدوا في الجانب الاقتصادي بيئة خصبة لممارسة الضغوط وانضم إليهم رجال أعمال مصريون وعرب وأجانب، اعتقدوا أن الفرصة جاءتهم على طبق من ذهب ليقوموا بالضغط على الرئيس كي يخضع لمطالبهم ويحصلوا على المزايا والامتيازات التي كانوا يحصلون عليها قبل ذلك. ونشير هنا إلى أن حجم أعمال بعضهم كان قد تجاوز 70% من إجمالي مشروعات التنمية في الدولة!
بهذا الشكل، يمكننا أن نقول إن هذا الشر لا بد منه. لكننا نعرف أيضاً أن رفع الدعم، ولو جزئيا، يأتي بمردود عكسي ونتائج سلبية على المواطنين، وأن ارتفاع سعر البنزين والغاز والسولار ترتفع معه بالضرورة والتبعية أسعار تعريفة المواصلات بكل أنواعها بصورة عشوائية، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكلفة الإنتاج للمصانع التي تستخدم الوقود في تشغيل الماكينات وخطوط النقل. كما يحدث في المقابل، تراجع كبير في القوة الشرائية للمرتبات، ومن ثم زيادة في استمرار حالة الركود والكساد الاقتصادي، في ظل استغلال وجشع التجار نتيجة غياب الرقابة وعدم قدرة الدولة على ضبط الأسعار.
ونشير هنا إلى أنه كانت هناك وعود وتطمينات بأن المواطن البسيط أو محدود الدخل لن يتأثر بالظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، وأن السلع الأساسية لن يحدث تصعيد في أسعارها. وهي الوعود التي لم تتحقق. بل رأينا التوجه الأساسي لحكومة شريف إسماعيل يناقضها ويخاصم استقرار الأسعار، مع التسليم بأن كثيرا من القرارات الصعبة كان لازما وضروريا لتحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي. فمن الطبيعي أن يتم رفع أسعار سلع بعينها من أجل الحصول على الأموال اللازمة لاستكمال المشروعات المخطط لها. فقط كنا نتمنى لو تمت مراعاة محدودي الدخل والسلع الأساسية وهو ما ننتظر تداركه خلال الفترة المقبلة.
فهل تكفي تصريحات شريف إسماعيل التي تلت القرار، والتي أعلن فيها أن الأسعار الجديدة للوقود تأتي ضمن خطة خفض الدعم التي بدأت 2014 وتنتهي 2019 وفق توصيات صندوق النقد الدولي، وأنه لا مفر من القرار قبل حسم قضية الدعم العام القادم؟!
رئيس الوزراء، لفت إلى أن "المرحلة الحالية لا تحتمل تأجيل القرارات إذ لا بد من مواجهة قرارات الدعم بحزم ليصل إلى مستحقيه، وإلا فالعواقب وخيمة على الجميع والقادم سيكون أسوأ". كما أعلن عن زيادة في أسعار الكهرباء يبدأ تطبيقها في أغسطس المقبل لفواتير يوليو، مشيراً إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولية قراراتها، مؤكداً أن حجم الدعم وصل إلى 150 مليار جنيه وأن الموازنة العامة للدولة لم تعد تتحمله. وفي المقابل، أوضح أن الزيادة لن تؤثر على تذاكر المترو والقطارات وحتى على رغيف العيش إذ أعلن وزير التموين أن الحكومة ستتحمل فارق تكاليف إنتاجه بسبب رفع سعر الدولار.
وما أثار الدهشة أكثر، هو تصريح أبو بكر الجندي، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، حينما أعلن عن حرص الرئيس السيسي على معرفة تأثير القرار على محدودي الدخل بشكل خاص والمواطنين بشكل عام، مما دفع المركز لإجراء دراسة على مختلف المحافظات ووسائل المواصلات لمعرفة نصيب الفرد من الزيادة.
حتى نكون منصفين، فإن الحكومة لا تتحمل العبء وحدها لأنها جزء من الشعب، والمواطن يريد الاستهلاك ولا ينتج، ودائمًا ما يحمّل المسؤولية للحكومة. ، والشائعات من أهم الأسباب المساهمة في الغلاء، فالمواطن لا يدرك حقيقة الواقع، وأي السلع التي ارتفعت أسعارها، وقيمة ذلك الارتفاع، إلا أنه يردد ما يتم تداوله، دون وعي. بما يعني أن هناك ارتفاع أسعار مبرر وآخر غير مبرر، وأن الحديث المتواصل عن وجود ارتفاع أسعار بشكل عام دون التدقيق هو أصل الارتفاع.
الكل يتحمل نصيبًا من التهمة، فالدولة مسؤولة عن جزء من زيادة التكاليف؛ لأنها لا تتدخل، وتكتفي بالاعتماد على آليات السوق الحر، وهناك جزء كبير من ارتفاع الأسعار يقع على عاتق التجار، فهم يستغلون المواسم لزيادة الأسعار بشكل جنوني، مستغلين عدم قدرة الحكومة على التحكم في السوق، فهناك ما يزيد عن 3 آلاف مركز تجاري، ولا تستطيع الجهات الرقابية متابعتها أو ضبط أسعار السلع والسيطرة عليها؛ لعدم وجود قانون يعطيها الحق في التدخل في السوق بتعديل الأسعار.
كما يتسبب المواطنون أحيانًا في رفع الأسعار بسبب كثرة الطلب في فترات المواسم، مثل رمضان والأعياد، فاستهلاك المواطنين يزداد خلال شهر رمضان، وبعض العائلات تصل لزيادات 3 أضعاف، بعكس شهور العام الأخرى، لكننا لا يمكن أن نعتبر المواطن هو المسؤول الوحيد عن ذلك؛ فتزايد شراء السلع لتخزينها في فترة معينة أو في مواسم بعينها يستغله التجار احتكاريًا لزيادة أسعارها.
وعليه، تكون الكرة في ملعب الحكومة ومدى قدرتها على معالجتها للوضع الاقتصادي الكلي وكيفية مواجهتها للتضخم، والهبوط بمعدلاته إلى مستويات معقولة، وزيادة الأجور وضبط الأسواق لضمان عدم ارتفاع أسعار السلع التي لا يوجد مبرر حقيقي لارتفاعها، مع توسيع شبكة الضمان الاجتماعي لتغطي كافة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، والتي هي غالبية عدد السكان.
وهكذا، تكون الحاجة ملحة وضرورية لوجود بورصة للأسعار؛ لتحديد السعر، ومحاسبة من يخالف الأسعار، بأن تقوم المؤسسات الحكومية وجهاز حماية المستهلك بدور الرقيب على السوق، وأن تحدد الربح، كما تفعل بعض الدول بتحديد هامش ربح التجار بـ 20% للملابس، و25% للسلع الغذائية، وهذا الأمر المتبع في اليابان وإنجلترا مثلاً.
3
ومن المعضلات، أن يحدث ذلك، بعد أن توقع تقرير جديد أن يحمل عام 2017 "تفاؤلا حذرا" للاقتصاد المصري، بشكل يعتمد أساسا على قدرة الحكومة المصرية الحفاظ على برامج الإصلاح والتنفيذ المحكم لإستراتيجية التنمية المستدامة. ولا أتحدث عن تقرير محلي بل عن النسخة الـ16 من تقرير "التوقعات الاقتصادية في إفريقيا"، الذي صدر في 22 مايو الماضي، بشراكة بين البنك الإفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو التقرير الذي ركز في نسخته الجديدة على التصنيع.
قال التقرير إنه في حالة استمرار إصلاح السياسات الاقتصادية والبنيوية في مصر كما حددت ذلك خارطة الطريق، فيتسارع النمو الاقتصادي خاصة مع عودة الثقة لدى المستثمرين وتطور إنتاج مجال الغاز وعودة النشاط السياحي، رغم المشاكل الداخلية والارتباك الاقتصادي العالمي الحاصل، متحدثا عن أنه بوسع مصر الاعتماد على مؤهلات المجالات الصناعية ومحال المقاولات من أجل تحسين النمو وخلق فرص العمل.
وأبرز التقرير أن احتياطي العملة الصعبة تحسن منذ اتخاذ البنك المركزي المصري لقرار تحرير قيمة العملة نهاية 2016، غير أنه مع ذلك، يبقى من الصعب محاربة العجز في الموازنة والميزان التجاري خلال هذا العام، رغم بذل جهود في هذا الصدد تعتمد على قانون مالية العام الماضي ووضع مشروع قانون للاستثمار وارتفاع العائدات من الضرائب.
وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي بمصر إلى 4.6 بالمائة بدل 3.9 المسجلة عام 2016، إلّا أن نسبة التضخم سترتفع وفق التوقعات إلى 16.9 بالمائة هذا العام. وتابع التقرير أن الاقتصاد المصري يبقى متنوعا إجمالا، إلّا أنه ورغم وجود تصنيع قوي، فالمستثمرين لم يستطيعوا خلق تغيير حقيقي في خلق مناصب العمل، كما أن النمو الاقتصادي بالبلاد يعتمد كذلك على ضرورة توسيع الولوج إلى الموارد الطبيعية والرأسمال وتوفير التكنولوجيات الحديثة واليد العاملة المؤهلة.
4
وقت إعلان وثيقة تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، كان من أبرز المسائل، التي أثارت جدلا واسعا فور الكشف عنها، أربعة أمور أساسية، أولها الاتفاق بين الحكومة والصندوق على خفض دعم المواد البترولية ليصل في عامي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ إلى ١٩ مليار جنيه، من إجمالي قيمته البالغة في ٢٠١٦ - ٢٠١٧ حوالي ٦٢.٢ مليار جنيه. أي أقل من الثلث، وهو ما يعني أن أسعار المواد البترولية كافة سوف تشتعل، حيث أن البديل الوحيد أمام الحكومة لخفض الدعم على المواد البترولية تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي هو رفع الأسعار، وخاصة أن أي زيادة في الإنتاج لم تتحقق كبديل لرفع الاسعار. كما أن ارتفاع الاسعار لتخفيض الدعم سوف يكون كبيرا للغاية، لكي تتمكن الحكومة من تحقيق المعدلات المطلوبة حسب الاتفاق مع الصندوق، وبخاصة في ظل ارتفاع تكاليف استيراد المواد البترولية، التي تستوردها مصر من الخارج لتغطية الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من الضعف، وما يتوقع من الارتفاعات لأسعار النفط عالميا بعد قرار دول منظمة الأوبك تخفيض الإنتاج لرفع الأسعار.
أما المسألة الثانية، فكانت أم الاتفاق، الذي كشفت عنه وثيقة صندوق النقد الدولي المعلنة، تضمن كذلك، رفع الدعم الكامل عن الكهرباء بحلول عام 2020، وهو ما يعني تحديد أسعار الكهرباء وفقا لسعر التكلفة. وذلك يؤشر إلى أن الأسرة المصرية سوف تتحمل بعد ثلاث سنوات التكلفة الكاملة مع عدم رفع المرتبات أو توفير موارد تسهم في رفع مستوى معيشة المصريين.
والمسألة الرابعة هي أن الحكومة المصرية وافقت على تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017 - 2018. وما إن جرى الكشف عن هذا الأمر حتى انهارت البورصة المصرية في غضون ساعات، وحققت خسائر بلغت أكثر من 19 مليار جنيه خلال يوم واحد، ما حدا بالرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدعوة إلى اجتماع عاجل ظهر الخميس ، 19/01/2017، برئيس الحكومة والوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة المعنية، واتخاذ قرار بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ٣ سنوات بعد انتهاء موعدها المحدد في محاولة لإنقاذ البورصة من الانهيار، وأيضا لتشجيع المستثمرين.
وتعلقت المسألة الرابعة بما كشف عنه الرئيس التنفيذي لصندوق النقد حين قال إنه فوجئ بأن حجم انخفاض الجنيه المصري كان أكثر مما كان متوقعا، وهو ما يكشف عن أن الحكومة المصرية لم تدرس بشكل حقيقي الآثار المتوقعة لاتفاقها مع صندوق النقد على العملة الوطنية.
وفوق كل ذلك، كان من أخطر ما توقعه رئيس بعثة الصندوق هو الارتفاع المتوقع لحجم الديون الخارجية على مصر من حوالي 60 مليار دولار حاليا إلى 66 مليار دولار مع نهاية العام الحالي 2017، وإلى 102,4 مليار دولار بحلول العام 2020.
5
لسنا حالة متفردة، أو غير مسبوقة. إذ إن تفاوت التنمية الاقتصادية والتغيير الاجتماعي في العالم كله، يضعنا أمام تناقضات وتباينات حادة. وهي ليست إلا نماذج مصغرة من اللا مساواة القائمة بين العالمين الموجودين على كوكبنا: ما يسمى العالم المتقدم والعالم المتخلف العالم الأول والعالم الثالث، البلاد الفقيرة والبلاد الغنية. والانقسام الكبير ضمن كل دولة فقيرة هو أشد ترويعًا، لأن التباينات هنا شديدة الاقتراب بعضها من بعض.
ولذلك فإن ذلك التفاوت أنتج قضية جديدة أو أنها تبدو كذلك، وهي قضية العولمة، وهي القضية التي باتت تشغل الآن مساحات واسعة من الفكر الإنساني المعاصر، ونتيجة لذلك أفرزت تلك القضية الشائكة العديد من الاتجاهات التي ينبغي أن نتناولها من منظور عقلاني شامل، يحيط بها من مختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والإعلامية والحضارية، بالإضافة إلى المنظور الإنساني الذي يقدم أطروحات متعددة للسياسات الليبرالية الحديثة التي تعتمد عليها العولمة، وترسم لنا صورة المستقبل بالعودة إلى الماضي السحيق للرأسمالية. وقد وجدت تلك الأفكار انعكاسها الواضح في السياسات الاقتصادية الليبرالية التي تطبق الآن في مختلف دول العالم دون مشاركة الناس أو موافقتهم على تلك السياسات.
وهناك من يعتقد أن العولمة ما هي إلا نتيجة حتمية خلقتها سياسات معينة، بإرادة الحكومات والبرلمانات التي وقعت القوانين التي طبقت السياسات الليبرالية الجديدة، وألغت الحدود والحواجز أمام حركات تنقل السلع ورؤوس الأموال وسحبت المكاسب التي حققها العمال والطبقات الوسطى، وانتهاء بالتوقيع على اتفاقية منظمة التجارة العالمية (الجات) التي ستتولى العقوبات على من لا يذعن لسياسة حرية التجارة. ففي كل هذه الأمور لم تكن هناك حتميات لا يمكن تجنبها، بل إرادات سياسية واعية بما تفعل وعبرت عن مصلحة الشركات دولية النشاط.
وعلى ضوء ما سبق، سعت بعض الدول إلى ترشيد الرأسمالية في بلدانها، وعملت على ضبط عوامل تطور المجتمع والسلم الاجتماعي، وضرورة وجود طبقة اجتماعية متوسطة متحركة وحيوية، بحيث يكون هناك اقتصاد فيه بدائل وخيارات متعددة، وضبطت من خلالها العملة النقدية. وهذا ما يعكس نوعًا من التقارب الأمريكي الروسي في ظل نظام نقدي دولي جديد، ويعكس (ضمنًا) حكمة الصين والهند وأوروبا في إيجاد دوافع للتفاهم حول السياسات النقدية.
هذه السياسات ذات صلة مباشرة وغير مباشرة بالبعد الاجتماعي للنظام الاقتصادي الجديد تكمن في المجتمع، لأسباب ما هو عليه، وكيفية تغيره. ولذلك سعت المنظمات والهيئات الدولية والمراكز البحثية إلى دراسة تلك السياسات وأبعادها المختلفة التي جمعت بين كل ما هو فلسفي أو سياسي أو تاريخي أو أخلاقي، ومن جانب آخر، ما بين علوم سياسية أكثر ارتباطاً بمشكلات الواقع، مع طرح نظريات اجتماعية عامة، ووضع قوانين لتفسير الظواهر والتحولات الاجتماعية. وتقديم تنبؤات يمكن الحكم على صحتها من عدمه، إذا ما كانت في إطار سياقها الاجتماعي المناسب وقادرة على التجديد والتصحيح الذاتي بشرط توافر درجة عالية من الشفافية من أجل تجنب تضارب المصالح.
غير أن الغريب والمثير للدهشة هو أن تجد الحكومة غير منــشــغلة بما يدور حولها وبينما الرئيس مهموم بالإنجاز، ترى الحكومة تشارك في الاجتماعات مثل الآخرين.. تسمع ولا تضيف.. تنصت ولا تبدع.. وكأن ما يعنيها فقط هو أن تمر الأيام. وكأنك أمام حكومة موظفين، لا حكومة تقوم بمهمة في إطار التحول والإصلاح!











